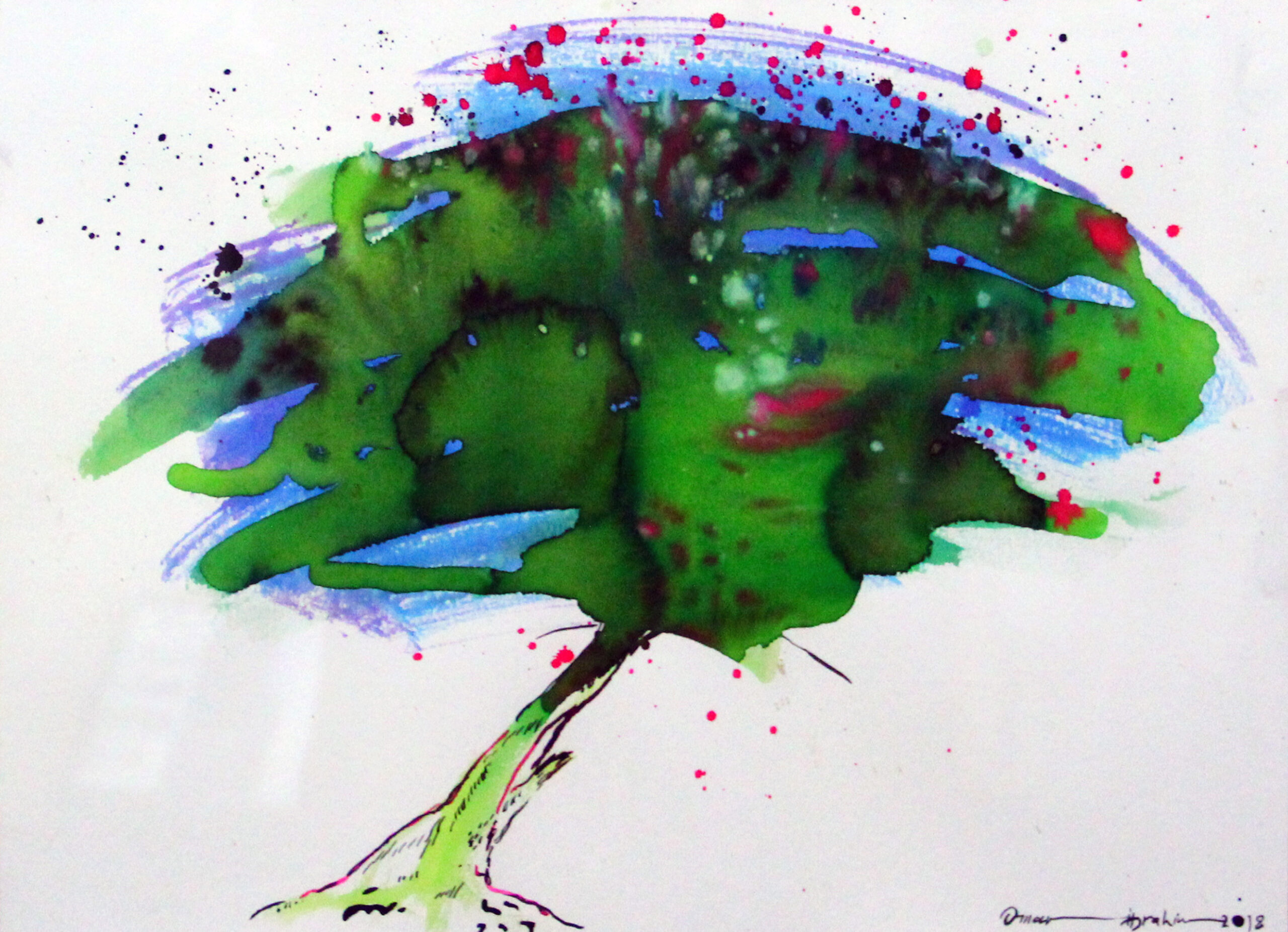يُقارَن بحسرة بين جهود أبي أحمد لإطفاء الحرائق في بلده وبين تلك التي أشعلها عبد الملك الحوثي في بلاده.. أو تقارن الوساطة التي قام بها الرجل في السودان، بدلاً من مد الأطراف بالمال والسلاح، مع قام به بن سلمان وبن زايد، من الانخراط في الحرائق، من اليمن الى ليبيا.
في كانون الأول /ديسمبر الفائت، من أوسلو، ومن على منصة جائرة نوبل للسلام، ألقى أبي أحمد رئيس وزراء أثيوبيا الشاب (43 عاماً) خطابا شجاعاً وذكياً. وكان ذلك استثناء، قد اشتهر قادة بلدان القارة الإفريقية بحروبهم الدموية الطويلة والشرسة، بينما اصطف أبي أحمد إلى جانب نيلسون مانديلا.
عندما دعا أبي أحمد العالم للاستفادة من تجربة بلده، فقد كانت هناك أخبار جيدة تأتي من القارة السمراء، كما قالت رئيسة لجنة جائزة نوبل للسلام في خطابها بالمناسبة: أن المقولة التاريخية بأنه لا توجد أخبار جيدة تأتي من القارة السوداء قد انتهت.
منحتني الأقدار فرصة الاستماع المباشر لخطاب أبي أحمد، فقد كنتُ في قاعة الحضور مدعوا للحديث عن اليمن علي هامش الاحتفال بجائزة نوبل للسلام. وجاءت تلك الدعوة من لجنة الجائزة لأن بلدي اليمن يمر بتجربة حرب مستمرة منذ سنوات. وشعرت أن مهمتي هي إلقاء درس يصف للعالم أهمية السلام الذي يتحدث عنه أبي أحمد، الفائز هذا العام بجائزة نوبل للسلام. لكني اخترت زاوية أخرى وهي الحديث عن بلدي كعبرة للعالم كي يتجنب بكل قوته مثل تلك المآسي التي يعاني منها 30 مليون يمني يعيشون منذ سنوات تحت رحمة الأسلحة الذكية والغبية.
في القاعة، وعندما دارت هذه الهواجس في رأسي بينما كان أبي أحمد يتحدث، كانت دمعة بطيئة تنحدر على خد زميلي وصديقي بيتر ساليسبيري، الباحث في مجموعة الازمات الدولية، والقادم من عالم آخر أصبحت فيه الحروب تاريخاً بعيداً. وقد صار خيال أبناء هذه البلدان متواضع جدا أمام الكوارث التي تخلفها الحروب، بما فيها الحرب في بلدي اليوم. تأثر ساليسبيري بقوة بما قاله أبي أحمد في خطابه، وهو يروي قصته عندما اكتشف خلال أقل من دقيقتين من إصلاح هاتفه الخليوي، أن كتيبته قد قُتلت بالكامل، بينما نجا هو من الموت ليس ليكون شاهداً على الحادثة التي تتكرر في الحروب ولكن ليكون مستقبلاً، وبعد انتهاء الصراع في بلده داعية للسلام من موقع القرار. فهو ضحية للحرب بطريقة مختلفة، فهي حفظت روحه، ليرويها فهو قادم من مستنقعاتها، وليس من موقع السياسي المنظّر في مفاهيمها بشكل مجرد بل هو روى بحس مباشر كيف انغرست سكاكينها في جسد شعبه.
لقد كانت لحظة مهيبة. ومن الصعب تفويت تلك المشاعر الخاصة بجنوب العالم، لدى الجمهور الذي تلقى كلمات أبي أحمد بخشوع، فتحكمت في مزاج وتفاعلات القاعة طوال استرساله فيها، وكرست لحظة فرائحية، واعترافاً نادراً بالأشياء الثمينة التي يمكن أن تعيش حولنا حتى في أحلك اللحظات،أو لدى من كان مثلي، قادماً من بلدان الحرب، فولدت تلك الكلمات الأمل المفتقد.
كلمات أبي أحمد جاءت كصفعة في وجه الاستعمار القديم والجديد بكل أشكاله وسلوكياته وأخلاقه، وفي الوقت نفسه في وجه العنصرية التمييزية الوقحة ضد لون وبشرة شعوب كأثيوبيا.. عنصرية جامعة لا يستطيع حتى من يتنصلون عادة منها أن ينكروا وجودها، مثلما يفهل أبناء بلدان تعرضت للاستعمار، وعاشت صراعات دامية وكارثية على امتداد الخريطة، من بلدي اليمن إلى لبنان.
أثيوبيا بلد جميل، يشترك مع اليمن بالقات والبن، فهناك اتفاق ضمني على أن أصل نبتة البن اثيوبي، وابتكار مشروب القهوة يمني. لكن ذلك الاتفاق لم يتحقق بما يخص الجانب التاريخي، حيث يتنازع المؤرخون في البلدين حول موطن بلقيس، ملكة سبأ الشهيرة التي وردت قصصها في الكتب السماوية من التوراة إلى القرآن ..
من المهم الاعتراف بنموذج أبي أحمد لفض النزاعات، سواء بين بلده وارتيريا، أومن خلال مفاوضاته مع مصر حول سد النهضة، أو عبر تلك الجهود مع الدول الأخرى التي تعيش تحولات سياسية ومجتمعية حادة، كالوساطة التي قادها في السودان.
في كل تلك الحالات فلا تزال جهود السلام التي قادها أبي أحمد طرية، وأمامها تحديات أكثر من الفرص. لكنها في نهاية المطاف حساسة تجاه الطبيعة الإقليمية للمشاكل، وتختار بناء على ذلك، رسم حلولها. وبهذا المعنى ففرص نجاحها أعلى من مسارات فض النزاعات الدولية السريعة التي تقودها الأطر الدولية عادة، بطريقة غير حساسة للتعقيدات المتغيرة بتغير المكان. وهي علاوة على ذلك، إعادة اعتبار مهم للذات لجنوب العالم – وتحديداً الأفريقي- بصفته ليس فقط قادراً على النجاة من ويلات الأسلحة الغربية والشرقية المصدّرة إليه، بل ومسؤولا بما فيه الكفاية ليقود جهود سلامه بنفسه، دون انتظار المبادرات الدولية للسلام التي تستمد موازناتها من عمولات صفقات الأسلحة الغربية بالأساس.
ثم هناك أمر آخر يخص نموذج القدوة. فقد يفشل مسار أبي أحمد في نهاية المطاف، وقد يُفشّل عمداً. وهناك الكثير من الانتقادات المحلية تجاهه في اثيوبيا. ولكنه يبقى إرثاً يترك نموذجاً جريئاً للطموح إلى السلام، وهو ما يحب أن يحظى بالاحتفاء. لا يستطيع المرء مثلاً إلا أن يقارن – بحسرة – بين الجهود التي يقوم بها أبي أحمد لإطفاء الحرائق في بلده وبين تلك التي أشعلها عبد الملك الحوثي في بلاده مثلاً، ولو كانت مقارنة مجحفة بين الرجلين. أو حتى تلك التي يقودها أبي أحمد من اثيوبيا الفقيرة والتي بالكاد تقف على رجليها بالسلوك المسؤول نحو جارتها السودان عبر الانخراط في دور الوساطة بدلاً من مد الأطراف بالمال والسلاح، مقارنة بما قام به قائدان شابان كمحمد بن سلمان ومحمد بن زايد، من دولتين قويتين وثريتين، مشعلين الحرائق أو منخرطين فيها من اليمن الى ليبيا، وذلك بدلاً من تسخير الموارد لإطفائها.
***
أواخر العام 2018، زرتُ اثيوبيا للمرة الأولى، وكان ذلك في بدايات تولي أبي أحمد السلطة، حينما دشن عهده بإطلاق سراح آلاف المعتقلين السياسيين، واتخذ إجراءات سياسية جعلت منه غير محبوب أحياناً، حتى وسط حاضنته العرقية المحلية، وهو القادم من مزيج ديني عرقي يمثل أكبر ديانتين وأبرز العرقيات في البلد(أم مسيحية من عرقية أمهرة، وأب مسلم من عرقية أرومو)، متنقلاً بين الهويات الصغيرة، بحيث استطاع التمرد عليها وترويضها بدلاً من الانخراط فيها والغرق بمحدوديتها.
أثيوبيا بلد جميل، نافس في قلبي بمجرد زيارته مكانة سوريا الذي لم ينافسها بلد آخر قبل ذلك. تشترك اثيوبيا مع اليمن بالقات والبن، بينما هناك اتفاق ضمني على أن أصل نبتة البن اثيوبي، وابتكار مشروب القهوة يمني. لكن ذلك الاتفاق لم يحدث بما يخص الجانب التاريخي، فللبلدين جذور لغوية وتاريخية مختلطة لدرجة الالتباس، حيث يتنازع المؤرخون في البلدين حول موطن بلقيس، ملكة سبأ الشهيرة التي وردت قصصها في الكتب السماوية من التوراة إلى القرآن.. وعندما تدخل مطار أديس أبابا لن تخطئ عينك كيمني أن السوق الحرة فيه تحمل اسم سبأ، بينما يقول اليمنيون أن مملكة سبأ يمنية بلغة لا تقبل الشك ولا الجدل، وآثارها التاريخية لا زالت حية في مدينة مأرب، العاصمة التاريخية لدولة سبأ.
من المهم إعادة الاعتبار للذات في جنوب العالم – وتحديداً الأفريقي منه – بصفته ليس فقط قادراً على النجاة من ويلات الأسلحة الغربية والشرقية المصدّرة إليه، بل ومسؤولاً بما فيه الكفاية ليقود جهود سلامه بنفسه، دون انتظار المبادرات الدولية التي تستمد موازناتها من عمولات صفقات الأسلحة الغربية بالأساس.
وعلى الرغم من مرور عقود على انتهاء حكم هيلا مريام “الاشتراكي” للبلد، فلا تزال الآثار الاقتصادية لتلك الحقبة ماثلة حتى اليوم فيما يتعلق مثلاً بالتحويلات المالية. لكن البلد يشهد نهضة واضحة المعالم، وإن كانت في طور الولادة، على أمل أن الرجل الأول الذي تتسم ملامحه بالخجل وسلوكه بالتواضع، كأي اثيوبي تلمحه عيناك في شوارع أديس أبابا، قد يمتلك الجرأة على ذلك.
سمعت كثيرا أن الأم الاثيوبية هي الأكثر حناناً وعاطفة في العالم. وقد اتسم حديث أبي أحمد في العشاء المقام على شرفه من قبل لجنة نوبل، بعمق أكثر من خطابه الرسمي، عندما قام من طاولته بجوار الملك والملكة وتحدث عن أمه، تلك المرأة التي ربته في القرية البعيدة، بمثالية عالية وعاطفة واضحة وغامرة، وطوال حديثه عنها كانت عيناه تطوفان أرجاء الغرفة وتعودان للتقاطع مع عيني زوجته القاعدة أمامه، ووزيرة السلام في حكومته التي نصفها أيضاً من النساء. لقد مسّني حديثه عن أمه بشكل عميق للغاية، ولربما كان ذلك أصدق حديث سمعته من سياسي.
في طاولة العشاء تلك الليلة، تصادف وجودي على طاولة واحدة مع أحد مساعدي أبي أحمد، نتحدث مع جيراننا في الطاولة عن أصول القهوة والملكة بلقيس، بسرديتين – بالطبع – مختلفتين. وقد ضحكنا كثيراً إذ كان لكل منا في مخزونه الشعبي ما يؤكد أسطورة بلاده، ولم يسعني وأنا أفكر في كل ذلك إلا أن قلت لجاري في الطاولة والجغرافيا: هذه ليلة جائزة نوبل وهي ليلتكم، وبناء عليه، سأسحب سرديتي مؤقتاً.
تنطبق بالطبع على أبي أحمد القاعدة الذهبية نفسها التي تنطبق على أي سياسي، وهي تقول أنه لا يجب أن تقول شيئا جيداً أو ايجابياً عن أي سياسي إلا إذا كان في السجن أو في القبر. وهذا “تحفظ” مبدئي يقابله ما تبدّى حتى الآن من الرجل… وذلك الأمل الدائم بأن تُكسر تلك القاعدة.